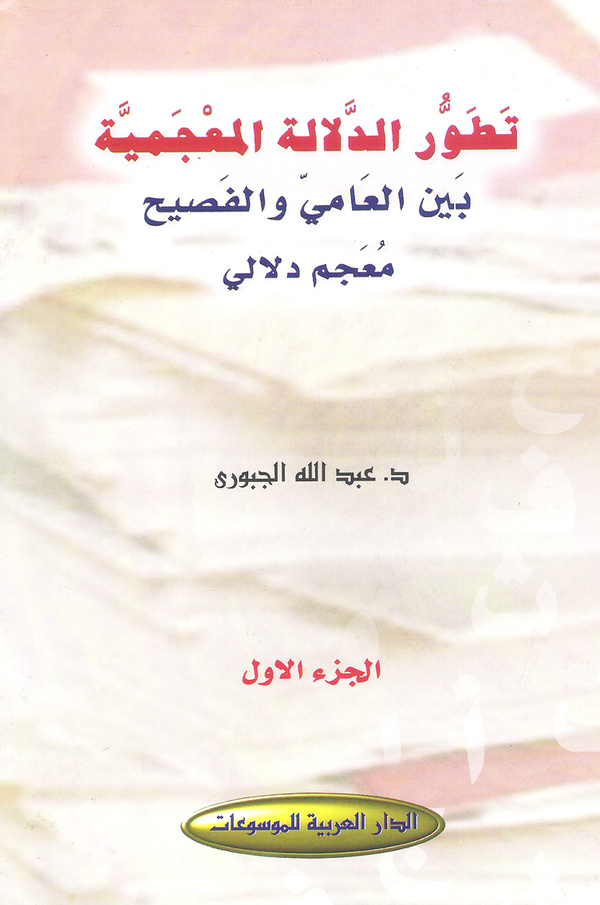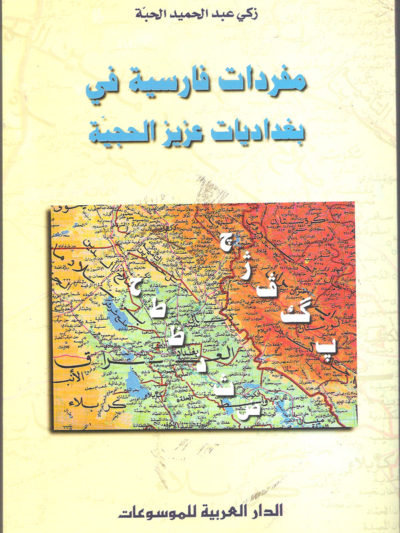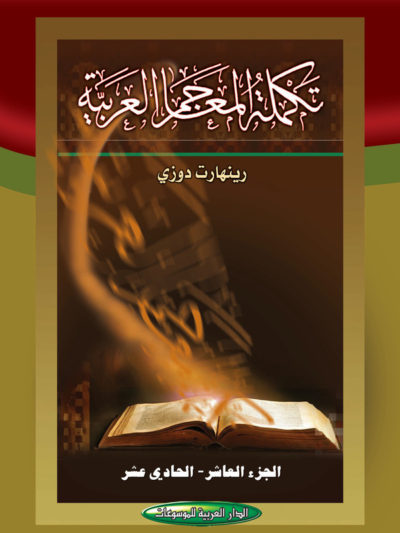الوصف
عرّف الراغب الأصفهاني (توفي سنة 412هـ) الدلالة بقوله هي: «ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعاني/ المفردات: 170 ولم تخرج المعجمات اللغوية عن هذا الحد». وعند الشريف الجرجاني: «هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدّال والثاني هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول منحصرة في عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص ووجه ضبطه» وهذا التعريف يتطابق مع (نظريات علم الدلالة) عند المحدثين. والدلالة: (فَعالة وفِعالة) بفتح الدال وكسرها، والفتح أفصح. والأصل في كلام العرب دلالة على لفظ على ما وضع له، ليدل المفرد على المفرد، والمثنى على اثنين، والجمع على جَمْع. وقد يخرج عن هذا الوضع قسمان: 1- مسموع، 2- ومقيس. وهذا كله يفسّر مصطلح علم الدلالة بأنه: (علم المعاني)/ معاني الألفاظ. وفرّق بينه وبين (علم المعاني) في البلاغة العربية، وإن كان الثاني جزءاً منه. الذي هو: «تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره». وأنه أكثر خصوصية من الوجهة اللغوية، في حين يكون (علم الدلالة) عاملاً على تنظيم عموم اللغات من خلال وضعه (النظريات والأسس) من هنا يكن وصفه بأنه (علم المعنى/ معنى المعنى) الذي ذكره الجرجاني أول مرة في (دلائل الإعجاز). أي: أنه (دراسة المعنى، أو: العلم الذي يدرس المعنى). أو أن الدلالة «قدرة الكلمة الواحدة في التعبير عن مدلولات متعددة». وحده – كما وقع عند الراغب -تلقّاه علماء اللغة والبلاغيون وعلماء الوضع والأصوليون بالرضا والقبول. وعليه قامت مباحثهم وعلى دراسته دارت مقالاتهم، حتى أصبحت جهودهم تراثاً عظيماً في دراسة (علم الدلالة) الذي توهم باحثون عصريون أنه من مبتكرات الغربيين، وإنما هو علم ابتكره (المسلمون). ولعل أقدم من بحث فيه من علماء العرب، هو: أبو نصر الفارابي (ت339هـ) الذي تجلّت جهوده فيه، في كتابيه: (العبارة: في المنطق 3 و10) و(الحروف/ 13( وحريُّ بالذكر القول أن الأصوليين هم من أكثر العلماء الذين – حفلت مباحثهم بالدرس الدلالي، فأينعت وربت، ومال إليها أهل العربية، فدرسها النحاة، وعالجها البلاغيون: لما بينها وبين (علم المعاني) في البلاغة من وشائج. لقد توسع الأصوليون في مباحثه، إذ إن البلاغة عندهم مناط استخراج الحكم الشرعي […] ضمن هذه المقاربات ومن محصلة الدرس الدلالي الذي وقع في كتب اللغات والمعجمات وكذلك عند الأصوليين بين الباحث دراسته هذه «تطور الدلالة المعجمية بين العامي والفصيح»، وقد نسّقها في قسمين: 1 – القسم الأول: درس فيه الدلالة عند بعض علماء اللغة والمناطقة والأصوليين. 2- القسم الثاني: المعجم. وفي دراسته للدلالة لمس خطر الاستعمال الذي كان أقوى أسباب التطور الدلالي. وقد عملت أسباب كثيرة على صنع التطور، سلط الباحث الضوء عليها في دراسته هذه، التي تعتبر والمعجم خطوة جيدية في دراسة (الدلالة المعجمية) ومحاولة في بناء المعجم اللغوي التاريخي، الذي جعله تطبيقاً لما ذكر من قوانين تطور الدلالة، ونهج فيه نهجاً يتفق والبحث الدلالي – التاريخي، ومن أظهر بنوده: 1- ذكر الباحث اللفظ كما ورد في المعاجم اللغوية ثم في استعمال أصل الأدب، والتاريخ والعلوم الأخرى. ثم ليأتي على ذكر نظائر له في اللهجات العربية المعاصرة – إن وجدت، التي أطلق عليها اسم: (العاميات العربية)، 2- حاول الباحث تتبع الأصل اللغوي في العربية (القديمة) وإشارته إلى وضعه في أي لغة تفرقت عنها. 3- اتضح للباحث أن كثيراً من الألفاظ الأعجمية هي من أصول عربية، كانت شائعة فيها ثم اندثرت في تراخي الزمن، بعد أن استقرت في لغات أعجمية كانت قد استعملتها في زمن غابر.. ثم عادت إلى العربية بعد ظهور الإسلام، ومنها كثير مما قيل له: (دخيل أو معرّب) من هنا تسرّع باحثون أو لغويون إلى عزوها إلى (المعرب أو الدخيل) وهي عربية. 4- انتهى من خلال دراسته لمواد التطور المعجمي إلى بعض الملاحظات التي أشار إليها في موضعها. 5- تتبع الباحث – ما وسعه جهده. 5- لتاريخ بعض الكلم العربية التي دُرست، سعياً لإثبات أصالتها العربية، وكان دليله (منهج التأثيل/ التأصيل اللغوي). 6- هذا وقد قام الباحث إلى تنسيق مواد هذا المعجم الدلالي على حروف المعجم، وجعله (ثلاثي التركيب). وأخيراً يمكن القول بأن متابعة تطور البلاغة المعجمية كشف كثيراً من تاريخ العربية، خاصته ما يتعلق بالمعرب والدخيل، وبالكلم المولد في العصر الحديث، وعليه قام الباحث بدراسة الدلالة فيه من وجوهها الثلاثة: 1- الدلالة السلوكية، 2- الدلالة التوليدية، 3- الدلالة المنطقية.
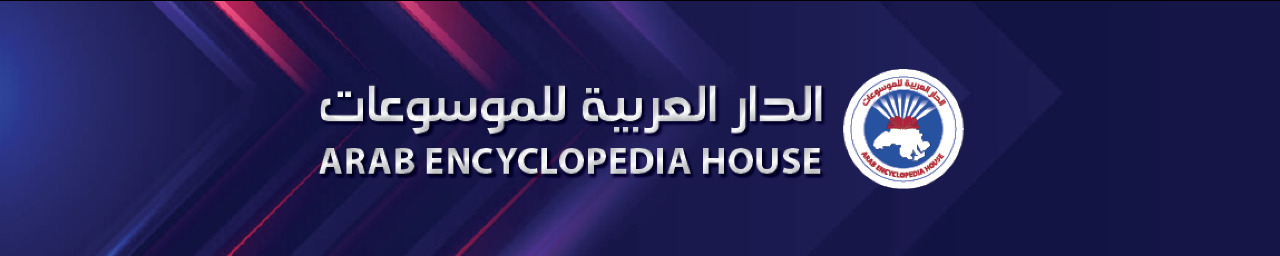 الدار العربية للموسوعات
الدار العربية للموسوعات